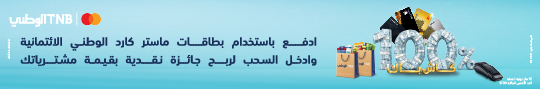المقاطعة بوصفها فعلًا طائفيًا: قراءة في المضامين والممارسات
تشير فكرة المقاطعة في تعريفها الاصطلاحي والإجرائي إلى كونها أداة احتجاج جماعي سلمية متعددة الاستخدامات تحمل أبعادًا سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وطائفية، تُستخدم للتعبير بمنطق واضح ومدروس عن الرفض تجاه جهة معينة، سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو مجموعة بشرية، عبر الامتناع المنظم عن التعامل معها بهدف الضغط لتغيير سياساتها أو ممارساتها وبالتالي إخضاعها.
من وجهة نظر قانونية يمكن أن نميز بين المقاطعة الأولية التي تكون من الحكومات مباشرةً تجاه المجموعات الهدف، كمقاطعة الأحزاب؛ والمقاطعة الثانوية التي تشمل أطرافًا ثالثة هم الأفراد والنقابات والمجتمع المدني ضد المجموعات الهدف. فعل المقاطعة بمفهومه الشعبوي هو فعل تجاري-اقتصادي هدفه تقليص الهوة بين المنتج والمستهلك أو للضغط على رؤوس الأموال لتحسين أجور عمالهم، وتطور هذا الفعل ليشمل المستوى الاجتماعي والسياسي النخبوي، فقد كانت فعالة في الحركات الحقوقية (مثل حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة) ومؤخرًا في حملات التضامن مع قطاع غزة من خال مقاطعة مجموعة شركات تتعامل مع إسرائيل، وحملات المقاطعة المنتشرة عبر الوسائط الرقمية ضد الشركات التي تنتهك قيم العدالة الاجتماعية. وعلى المستوى الدولي، استخدمتها الدول والمنظمات للضغط السياسي كدعوة لمقاطعة أولمبياد موسكو عام 1980 أو قطع العلاقات مع روديسيا وجنوب أفريقيا خلال الفصل العنصري. بيد أن هذه الأداة، التي يفترض فيها العقلانية والمدنية والإنسانية، قد تُسوِّغ وتفرض طابعًا طائفيًا في المجتمعات المنقسمة، فتُستغل من قبل مجموعات بشرية ضد أخرى كأداة إقصاء ونهج هوية يكرّس الانقسام بدلاً من التغيير المدني البنّاء.
التوجّه الجمعي ضد طائفة
يبدأ الفعل الطائفي في المقاطعة عندما يُستهدف به جماعة دينية أو مذهبية بكاملها، ليس بسبب سلوكها السياسي، بل بسبب هويتها الطائفية فقط. فحين يُقاطع أفراد أو مؤسسات أو جماعات لأنهم من الطائفة الفلانية، بصرف النظر عن مواقفهم الفردية، تكون المقاطعة قد خرجت من فضاء النقد السياسي أو الأخلاقي إلى فضاء الفرز الهويّاتي. في إبريل 1933، نظّم النظام النازي حملة مقاطعة للمحال التجارية والمكاتب التي يملكها اليهود في ألمانيا، مبررًا ذلك بأنهم يشكّلون خطرًا على الأمة الألمانية.
لم يكن الهدف من المقاطعة سياسيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل كانت خطوة تأسيسية لعزل اليهود من المجال العام تمهيدًا لاستئصالهم. وقد استُخدم الاقتصاد كساحة لـلتمييز الطائفي بلغة عنصرية مغلّفة بالشعارات الوطنية. لم ينبع فعل المقاطعة الألمانية من "مظلومية نازية" حينها، بل نبع من استخدام مفرط للقوة Excessive use of power والحشد ضد اليهود بهدف إقصائهم وإبعادهم من الفضاء العام الألماني.
في حالات أخرى يبدو الفعل نابعًا من مظلومية طائفية معينة، والشعور بضرورة تكوين هذه المظلومية لمواجهة طوائف أخرى يدفع إلى مقاطعة طوائف أخرى. الآن حين تُستخدم المقاطعة كوسيلة لتعزيز الهوية الذاتية الطائفية، وإظهار السطوة والتفوق الطائفي Sectarian Supremacy، لا بهدف بناء موقف جماعي عقلاني، بل لاستثارة مشاعر التضامن ضد "عدو طائفي" مفترض ومتخيّل، فإنها تتحوّل إلى أداة إقصائية. وبالتالي يمكن القول إن المقاطعة هنا لا تُمارس بوصفها احتجاجًا على سياسات حكومية، لكن كنوع من الفرز الاجتماعي والسياسي والتموضع الجماعي في معركة هويّات وولاءات وانتماءات.
بعد تفجيرات سامراء الشهيرة التي فجّرت الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في العراق، انتشرت دعوات في بعض المناطق السنية لمقاطعة المتاجر التي يديرها شيعة، والعكس أيضًا. هذه المقاطعة لم تكن موقفًا من سياسة معينة، بل انعكاسًا لانقسام هويّاتي دموي، وتمظهرًا له في الاقتصاد اليومي. فبدلًا من العمل على ترميم النسيج المجتمعي، بات الاقتصاد وسيلة لإعادة إنتاج الفتنة وتوسيع الشرخ الطائفي.
خطاب طائفي مصاحب
إن أي مقاطعة تُرفَق بخطاب مذهبي يستدعي رموزًا دينية أو تاريخية طائفية، أو يستخدم لغة تمييزية إقصائية، لا يمكن أن تُفهم إلا في إطار طائفي. إذ لا يمكن فصل الوسيلة (المقاطعة) عن اللغة المستخدمة في الترويج لها، وفقًا لتعريف ميشيل فوكو لكل من اللغة والخطاب القائم على النسق الذي يُستخدم فيه هذه الوسيلة وفقًا لقواعد القوة والسيطرة.
لم تعد المقاطعة في بعض السياقات مجرّد موقف احتجاجي سياسي أو اقتصادي، بل تحوّلت إلى أداة ترميزية للهويّة الطائفية، تعكس انقسامات عميقة لا يمكن فهمها إلا ضمن سياقاتها الهوياتية المتجذّرة. في أيرلندا الشمالية، خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، لم تكن المقاطعة المتبادلة بين الكاثوليك والبروتستانت محصورة في المجال الاقتصادي، بل ارتبطت بعناصر شعائرية ودلالات رمزية عكست صراع الهويات بين الجماعتين. كانت المتاجر، المناسبات، وحتى العلاقات اليومية تحمل شيفرات دينية صارخة ومُميّزة، فأصبحت أداة للتأكيد على الانتماء الديني أكثر من كونها تعبيرًا عن موقف أخلاقي من قضية سياسية أو حقوقية. بهذا المعنى، لم تكن المقاطعة هناك وسيلة للتغيير بقدر ما كانت وسيلة لترسيخ الانقسام.
نموذج مشابه تجلّى بوضوح في سورية، في معارك السويداء الدامية في يوليو 2025، عندما أصدر تجار وصناعيون ومُلّاك مؤسسات ونشاطات وفعاليات تجارية بيانات دعوا فيها إلى مقاطعة دروز السويداء نتيجة لاتهامهم وتصديرهم على أنهم انفصاليون، على الرغم أنه لم يحصل سابقًا طيلة سنين الثورة أن صدرت بيانات مشابهة بحق طوائف أخرى.
الأمر ذاته قد حصل في لبنان، خاصة في الفترات التي أعقبت الحرب الأهلية، حيث نشأت اقتصادات مصغّرة تتمحور حول الطوائف، وتحوّلت بعض الأحياء إلى أسواق مغلقة لا تخدم سوى أبناء طائفتها. لم يكن هذا نتيجة قرار رسمي، بل بفعل التراكمات الطائفية التي وجدت في المقاطعة آلية لإقصاء "الآخر" وإنشاء واقع موازٍ للمجال العام الوطني.
أصبح الدعم الاقتصادي موجهًا طائفيًا، والمقاطعة هنا لم تُستخدم لمحاسبة سياسات فاسدة أو سلطات قمعية، بل لإعادة إنتاج الطائفة ككيان اقتصادي واجتماعي مستقل، منفصل عن الدولة الجامعة ومناقض لها؛ ويمكن وصفها أنها مقاطعة تصوغ الواقع لا لتعدّله، ولكن لتقسّمه.
من الرقابة إلى التخوين
الوجه الأخطر للمقاطعة بوصفها فعلاً طائفيًا ليس في توجيهها نحو "الآخر" فقط، بل حين تتحوّل إلى وسيلة تأديبية داخل الدولة نفسها.
حين تُفرض المقاطعة لا بوصفها موقفًا حرًا، بل التزامًا طائفيًا يُراقَب ويُحاسَب عليه أفرادُ المجتمع أفرادًا آخرين، فإننا لا نكون أمام فعل احتجاجي، بل أمام آلية ضبط اجتماعي تقوم على الإكراه وتقييد الحريات والإقصاء. خلال الحراك البحريني في 2011، ظهرت هذه الممارسات بوضوح، حيث انتشرت دعوات داخل الطوائف (الشيعية والسنية على حد سواء) لمقاطعة متاجر ومؤسسات تعود ملكيتها لأشخاص يُشتبه في تعاونهم مع السلطة. وسرعان ما خرجت المقاطعة من المجال السياسي المدني لتدخل إلى دائرة الرقابة الداخلية، فظهرت قوائم الخَوَنة، وتحوّلت الجماعة من فاعل سياسي إلى سلطة عقابية. ما يُثير القلق هنا هو أن المقاطعة، التي يُفترض أن تكون أداة لتحرير الناس من الاستبداد، تتحوّل إلى وسيلة لاستنساخ الاستبداد داخل الطائفة نفسها، باسم الهوية أو الثبات المذهبي؛ يُجبر الأفراد على الانصياع، وتُجرَّد المقاطعة من بعدها الأخلاقي، لتصبح أداة للانغلاق والتحصين، لا للمساءلة أو المطالبة بالحقوق.
من هنا، تتضح المعضلة الأخلاقية والسياسية الكبرى المرتبطة بالمقاطعة كفعل طائفي. فحين تُستخدم المقاطعة لتكريس الانقسام بدلاً من مقاومته، تصبح جزءًا من منظومة الهيمنة، لا أداة لنقضها. إن المقاطعة، مثل أي أداة احتجاجية، تحتاج إلى وعي وسياق وخطاب جامع، لا طائفي. في المجتمعات المتعددة، ليس الخطر في استخدام أدوات مدنية كالمقاطعة، بل في انزلاقها إلى أجندات هوياتيّة تكرّس التفتت. فما يبدو في الظاهر فعل مقاومة، قد يكون في العمق فعل انقسام، وما يُطرح تحت شعار العدالة وشعار الولاء للوطن، قد يتحوّل إلى مسرح للتخوين وإعادة إنتاج الطائفة كسجن رمزي واجتماعي.

التويجري عن "جنايات أبو ظبي في حق الأمة": شموس الحق لا يحجبها غربال

بينما يحصي البعض صيحات الاستهجان، يحصي الفلسطينيون شهدائهم .. مفارقات النظام الدولي وأخلاق...

عندما تُختزل القضية الفلسطينية في إدارة غزة

احتلال مرخّص قانوناً

غياب الفلسطيني والمراهنة على الزمن

فلسطين: عندما ينصب المجرم صانع "سلام"

لا تُحمِّلوا شعب فلسطين مسؤولية فشل أنظمتكم وأيديولوجياتكم