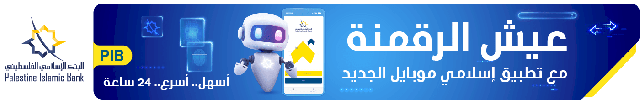الإسكندرية: ملمس الروح التي كانت هنا ولم تزل
صوته على الشاطئ، أسمعه الآن كما سمعته قبل 27 عاماً، حين نامت المدينة ولم ينم موج بحرها.
كنت هناك في ضيافة السيد أحمد البدوي، بطنطا حينما ناداني البحر والمدينة. لم يكن النداء إلى مصر المحروسة كما فيلم "النداهة" للمخرج حسين كمال 1975 المقتبس عن قصة يوسف إدريس، كان النداء للإسكندرية التي عرفتها من خلال الأفلام والكتب.
وهأنذا في هذا الصيف الحار أدخلها، وآب قمة الصيف. أدخلها فتعود معي أزمان دخولي الأول والأخير وما بينهما على مدار سنوات الدراسة، فما أن يطل صباح، وأقف على شرفة الفندق حتى أراه جالساً عند قاعدة تمثال سعد زغلول. جميل، ها نحن في مركز الإسكندرية، هنا محطة الرمل، ذكريات التجول واكتشاف مدينة عظيمة، ويوميات الطلبة. أهبط إلى المكان لأسلم عليه بعد غياب، فأجد أنه صار حبيس حديقة صغيرة، فأتساءل كيف استطاع الفتى الجلوس هناك. أزهد بالدخول إلى المكان المغلق، حتى لا أقع في جدل مع الحارس، إذ كيف سأبين له ارتباطي بالتمثال، مكان اجتماعنا القديم، وتأملنا للبحر ليلاً؟ وكيف سيرى صاحبي هناك الجالس في خفية منه؟
وما أن اقتربت من الكورنيش لأسير عليه، إلا والفتى نفسه يظهر لي ماشياً على الكورنيش مركز النظر على البحر وعلى آثار رطوبة البحر على البنايات. أتأمله قليلاً، ثم أذهب، نحو كشك الجرانين والمجلات: الأهرام والأخبار وروز اليوسف!
تود لو ذهبت إلى سينما أوديون لتنتظرها كما انتظرت قبل ربع قرن.
كنت أعرف طريقي جيداً نحو طبق الفول المصري البديع، والفطير المشلتت والعسل الأسود، متلذذاً بهما، حيث تكرر التلذذ بهما طوال الصباحات الأربعة، باستثناء عدم توفر الفطير في اليوم الأخير. كنت أتعامل مع فضاءات الأماكن، ومع الناس هنا بألفة: كأنني منهم!
ما أن أكون معهم، حتى تراني مندمجاً كمصريّ، يبدو أن السنوات الأربع التي قضيتها هنا كانت ملأى بالحياة المصرية، حيث لا أعتبر نفسي سائحاً أو زائراً، بل عائد لمدينته التي ظلت تسكنه كل هذه السنوات، من المعمورة حتى القلعة.
يظهر البحر والكورنيش، فألمحه هناك يسير معنا غير آبه بتحولات المكان، أختار طاولة تطل على البحر، وعلى قلعة قايتباي بشكل خاص، حيث يسكن صقر في علم مصري كبير يرفرف من بعيد.
1992
- تذكرة طالب؟
- فين الكرنيه؟
- نسيتو، بس والله العظيم إني طالب هنا.
بعد كل هذه السنوات ما زلت أتذكر بحب وحنان الحوار القصير بينها وبين زميلها المحاسب:
- ازاي تديه التزكرة؟
- ده حلف!
جميل هذا التدين الفطري الرائع.
تجولنا في القلعة، وسحرني مشهد الأمواج التي تضرب سور القلعة، ورحت أطل من كوات وشبابيك القلعة كمحارب قديم أو كشاعر، فأراني أطل على بحر عكا، هناك ليس بعيداً.
ولا أدري لم ما زال الطفل بائع الذرة المشوية مكانه يحيا على أمله:
- ازيك؟
- تمام يا بيه.
- ماشية؟
- مهي لازم تمشي يا بيه.
ذلك هو أمل الطفل بتحسن الأحوال في أسرته، التي يدعمها، فيقرأ في كتب المدرسة وهو يبيع الذرة في هذا المكان التاريخي. أنظر إلى الكوات من بعيد، بضع كيلومترات، فأحاكي فعل الممثلين في فيلم يوسف شاهين "الناصر صلاح الدين" الذي ظهر عام 1963 في الاستراحة، يشعل المصطافون سجائرهم، في حين أشعل الذكريات، ولا أكاد أطل على الكورنيش من أعلى النافذة حتى أرى نفسي شاباً صغيراً يتمشى لوداع الإسكندرية، ليحتفظ في ذاكرته بشيء من القلعة والأنفوشي، والفنادق والبنايات الجميلة، ومحطة الرمل، والبحر القديم بأمواجه التي لا تشيب.
وقتها اخترت الحنطور صباحاً، لوداع المدينة، لأرى المدينة بطريقة جديدة. وها نحن الآن بعد هذه السنوات نختار الحنطور، ربما هو نفسه من يدري؟ لنسير هنا في المكان نفسه ليلاً، لنغني معاً: الجوز الخيل والعربية لكارم محمود وشافية أحمد:
ـسوق يـا اسـطـي لـحـد الـصـبـحـيـة علـي راسي يـا هــانـم وعـيـنـيـا
الـجـوز الخـيـل.. والـعـربـيـة انـغـامـهـم كـلـهـا حـنـيـة
يـشـتـغـلـوا عـلـيـهـا الالاتـيـة وانـا سـايـق الـخـيـل والـعـربـيـة
أتجول قليلاً في الأسواق، أشتري بعض الكتب من دار المعارف، منها "الأيام" لطه حسن بأجزائه الثلاثة في كتاب واحد، وأشتري بشاكير ومناشف مصرية نوعيتها فاخرة، إضافة للذرة المشوية، لأكتشف أن الجنيهات المصرية التي حملتها معي لم يعد لها قيمة، حتى أن بائع الذرة لربما حسبني من أهل الكهف وأنا العائد له بفلوس قديمة!
فيليتسيا والمتنزه: رحلة وجودية، في الأزمنة والمكان الواحد.. هذا اليوم قبل الأخير، لا بد من المتنزه، ومن شط فيليتسيا، فإلى هناك لعلي ألحق به نهاراً في ظل هذه الزحمة على الكورنيش! هناك تكون رحلة أخرى، وسفر آخر، غريب، قريب، حنين، حنان، وإنسان، وتاريخ وحب..
تاكسي!
لم يبق غير القليل من الوقت لألحق ما تبقى من نهار البحر، المتنزه، ولأن الطريق من محطة الرمل للمتنزه لا تأخذ غير القليل من الوقت، فقد توقعت اللحاق بالشمس قبل الغياب. لكنا في ظل آب وزحام الصيف، تأخرنا في الوصول، رغم أن الأسطى استخدم الطريق الداخلي بعيداً عن الكورنيش.
أشتري تذكرة دخول للمتنزه، فيخطئ الموظف في الحساب، فأعيد له ما أخطأ به، فيشكرني. أدخل المكان ومعي زمان أربع سنوات مضت منذ 1988-1992. إنه المساء!
23 عاماً، كأنني نسيت بعض التفاصيل. اتجهت نحو مكان الفنار، وشاطئ فيليتسيا، ولكن بعد قليل اكتشفت أنني في المكان الآخر المقابل. مكان المتحف، عرفت أنني تهت فحزنت للذاكرة، كنت أظن أنني لن أتوه في هذا المكان الذي قضيت فيه ساعات كثيرة بل أياماً صيفية وخريفية وشتوية وربيعية.
اقتربت من شط فيليتسيا، فوجدت المكان من الخارج أطلالاً خربة، فحزنت متسائلاً: لماذا؟ الكبائن المتقادمة، لكنها من العراقة بحيث ما زالت تسجل حضوراً. كان عليّ أن أعيد دائرة الماضي، حين كنت أتنقل من الشط فالجسر، فالبيوت الملحقة بالقصر، الاستراحات، فالفنار.. فالبحر والليل! أما الاستراحات الملكية القديمة فقد حلّ بها بعض الضباط الأحرار بعد الثورة، لكن الزمن أيضاً لم يرحمها، فصارت قديمة، وجزء منها يتعرض لترميم.
- أين؟
- إلى الفنار!
- الدنيا ليل يا بيه انتهت الزيارة.
قلت للريس: كنت هنا قبل 23 سنة، ونفسي أشوفها تاني لأنني مسافر بكرة. فطلب الريس من أحد الموظفين بالسماح لي. هي طيبة هذا الشعب. تجولت هناك، وكلما سرت في هذا الليل الإسكندراني، كان نور الماضي يطلّ، فأتذكر. سرت حتى وصلت المكان الذي غنت فيه سعاد حسني:
بيت صغنن فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالع وريحة البحر هلة
حلم ولا حقيقة سيان عندنا المهم نكون سوا وكله على الله
ولو نغمض ويلا نلقى حتى الضلمة بمبى
كان ذلك من فيلم "أميرة حبي أنا" كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل. المكان المظلم ليلاً صار مضيئاً، فها هو حسين فهمي وسعاد حسني، ومشهد غرام تمنينا أن نعيشه عندما رأيناه أول مرة قبل سنوات. كنا أطفالاً حين ظهر الفيلم عام 1974. لم أره إلا بعد خمس أو ست سنوات على شاشة التلفزيون طبعاً.
اختلط النهار بالليل هنا، الماضي بالحاضر، والمستقبل ترى كيف سيكون في بلادنا؟ الشعور والفكر؟ الفن؟ والأدب؟ والحياة؟ ترحمت على سعاد حسني، وعلى زمن جميل كان هنا ومضى. وكأنني أمسح دمعة!
لم أكمل الدورة باتجاه الفنار، فأشرت بيدي مسلماً.. وعدت سارحاً متأملاً في الحياة، ومتحدثاً مع حراس المكان الطيبين، من الفقراء، مانحهم كثيراً من الحب:
- خلي يا بيه. مستورة يا بيه.
وقفت قليلاً هناك متذكراً الأفلام السينمائية، بنجومها، فظهر عبد الحليم حافظ، ونادية لطفي، وميرفت أمين، نجوم فيلم "أبي فوق الشجرة". هناك على الشاطئ القريب، ربما شاطئ المعمورة كانت أغنية "دق الشماسي" الشهيرة:
يا احلى شمس واحلى رمل واحلى مية احنا وشبابنا وحبنا اسكندرية
جايين على نسمة أمل نرتاح شوية والحر زي الشوق نهاره زليه قاسى
دقوا الشماسي
الأفلام والروايات هي دليلي للمكان قبل زيارتي للمكان قبل 23 عاماً، وخلال إقامتي هناك شاهدنا "آيس كريم في جليم"، وبعد سنوات أحببت فيلمي "صايع بحر، وصباحو كدب"..
ألتقي البروفيسور نبيل سليم أستاذ جراحة التجميل بكلية طب الإسكندرية، وهو كاتب وأديب وناقد، يكون اللقاء في محطة الرمل التي أحبها. نلتقي كأننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل. نتجول في المكان والزمان، ونجلس على الكورنيش على أحد المقاهي المشهورة والبحر أمامنا. نتحدث في الأدب والفن والسياسة والتاريخ. يعشق د. نبيل الإسكندرية ومصر، والأدب والطب. هو يدخل الستينيات بكامل حيويته، وأنا أودع الأربعينيات.. نتحدث عن التنوير، وعن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المهم أن من يستمع لنا سيظن أنني مصريّ، لعلمي بتفاصيل الحياة والتاريخ الثقافي والسياسي لمصر؛ فمن يحب بلداً يتعرف على تاريخها. أحدثه عن ارتباط العرب بمصر، وعن ارتباط فلسطين، وعن ارتباط أسرتنا، فمعظمنا تخرجنا من مصر. وهو الذي كتب على صفحته شيئاً عن لوحة مائة عام من التنوير وما آل مصيرها، وكيف كتبت مقالاً عن التنوير.
لكنْ ثمة أمل كبير هنا؛ فملمس الروح التي كانت هنا لم تزل:
جايين على نسمة أمل نرتاح شوية والحر زي الشوق نهاره وليله قاسى
دقوا الشماسي!

دعوةٌ للتخايل: ماذا لو كانت الشراكةُ(العرب وايران ) طريقًا لا صراع؟

الشرعية القانونية لاستهداف أيزان للقواعد العسكرية ألأمريكييه في الخليج - مقاربة في القانو...

هل نحن أمام نسخة جديدة من طوكيو وبرلين؟ قراءة في فكرة "مجلس السلام"

تحذيرات عاجلة في زمن التصعيد: السلامة أولاً فوق كل إعتبار

إيران تُشعل المنطقة والخليج يحسب خطواته بحذر

لم يطلب أحد أن تسلم حماس سلاحها لإسرائيل

كيف يمكن تحويل الاتفاقيات الاقتصادية من استجابة ظرفية إلى مشروع بنيوي مستدام في فلسطين؟