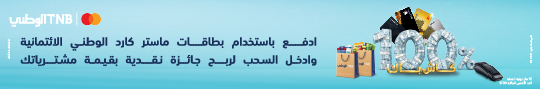الدستور والمجلس الوطني: بين الشرعية الإجرائية والشمولية السياسية
لم تضع الحرب أوزارها بعد، ورغم ما تفرضه جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، والهجمة المستمرة للمستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية من هدم للمخيمات وتوسيع للمستوطنات وقتل لكل إمكانيات إقامة دولة فلسطينية حتى على الجزء المتبقي من الضفة، إلا أن المستوى السياسي الفلسطيني لم ينشغل سوى بترتيب البيت الداخلي، في محاولة لتقديم صورة للفلسطيني تبدو كما يتوقعها العالم ليتقبله.
لذلك فوجئت الساحة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة بقرارين متتاليين للرئيس الفلسطيني: الأول، تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مع وضع شروط للعضوية في المجلس الوطني ومنظمة التحرير تمثلت في الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية، في إشارة إلى اتفاقية أوسلو والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. والثاني، تشكيل لجنة لإعداد دستور فلسطيني.
ورغم أهمية هذين المسارين في سياق الإصلاح السياسي والمؤسساتي، إلا أن توازيهما يثير إشكاليات قانونية عميقة، تتعلق بترتيب الأولويات، وشرعية التفويض، وشمولية التمثيل الوطني. وتهدف هذه المقالة إلى بيان أوجه التناقض بين المسارين، والتأكيد على عدم جواز الشروع في صياغة دستور قبل تجديد الشرعية التمثيلية للمجلس الوطني الفلسطيني، مع التوقف عند مسألة اشتراط الالتزام باتفاقيات أوسلو وتهميش قوى سياسية وازنة، ومدى تعارض ذلك مع المبادئ الدستورية والإصلاحية المتعارف عليها عالميًا.
ولا يسعنا الحديث عن لجنة صياغة الدستور الفلسطيني دون الاشارة الى انه وفي سنة 1999 تم تكليف لجنة لصياغة الدستور وقد صدر تكليفها من رئيس السلطة الوطني الفلسطينية في ذلك الوقت ياسر عرفات بعد تكليف من قبل المجلس الوطني الفلسطيني ووالمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علما ان اللجنة المذكورة برئاسة السيد نبيل شعث قد عملت على المسودة بعد عقد ما يقارب مائتي اجتماع وورشة عمل وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومع شخصيات اكاديمية وسياسية وقانونية وعربية ودولية
الإطار القانوني للمجلس الوطني الفلسطيني والشرعية التمثيلية
يُعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، بموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (1968 وتعديلاته)، السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني. فقد نصّت المادة (7) على أن المجلس الوطني هو "السلطة العليا التي تقر سياسات منظمة التحرير وتخطط برامجها"، كما خوّلته المادة (13) صلاحية انتخاب اللجنة التنفيذية ومساءلتها.
وبناءً على ذلك، فإن أي خطوة تأسيسية كبرى -مثل تشكيل لجنة لاعداد دستور جديد- يجب أن تصدر عن مجلس وطني منتخب. وان تجاوز هذه القاعدة يضعف الشرعية للعملية الدستورية، ويجعلها قائمة على إرادة تنفيذية فردية لا على تفويض تشريعي جامع.
هذا المبدأ يتفق مع الفقه الدستوري العالمي الذي يؤكد أن الدساتير يجب أن تصدر عن هيئات منتخبة أو مفوضة من الشعب، كما حدث في جنوب أفريقيا (1996) وتونس (2014). وعلى العكس من ذلك، عانت محاولات صياغة الدساتير عبر قرارات تنفيذية منفردة من أزمات شرعية وقبول مجتمع.
لكن خصوصية الحالة الفلسطينية، بما تحمله من تعقيد واستثنائية، تطرح سؤالًا مختلفًا حول شرعية أي دستور يصاغ في ظل إبادة جماعية وتجويع يمارسه الاحتلال الاسرائيلي. فما مدى تأثيره على وجدان الشعب؟ وكيف سينعكس على ذاكرته الجمعية من جهة، وعلى نظرة المجتمع الدولي من جهة أخرى؟
الدستور يعني أننا أمام عقد بين الدولة والشعب، يجب أن تتوافر فيه كل الشروط القانونية والإجرائية. لكن هذا العقد يحتاج إلى بيئة اجتماعية وسياسية حاضنة، فهل يستطيع شعب يرزح تحت الحرب والإبادة تحديدا في قطاع غزة أن يشارك في هذا العقد؟ وكيف سيتعامل مع مخرجاته؟ الامر الذي يطرح تساؤل كبير حول شرعية هذا الدستور الذي سوف يصاغ في ظل هذه الظروف !
القانون الأساسي الفلسطيني وتسلسل الشرعية
يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني (2003 وتعديلاته 2005) على مبدأ الشرعية الديمقراطية والتدرج المؤسسي. فقد نصّت المادة (2) على أن "الشعب مصدر السلطات"، والمادة (47 مكرر) على أن "المجلس التشريعي هو السلطة المنتخبة للشعب الفلسطيني".
ورغم أن القانون الأساسي ينظم سلطة الحكم الذاتي، إلا أن فلسفته القانونية تؤكد أن المؤسسات التمثيلية المنتخبة هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرارات المصيرية. وبالقياس، فإن المجلس الوطني الفلسطيني، بصفته الهيئة الجامعة للشعب الفلسطيني، يجب أن يكون هو الإطار الذي يمنح الشرعية لأي لجنة لإعداد دستور وطني، لا أن يُشكَّل بقرار رئاسي مباشر.
وهذا يتفق مع مبدأ التدرج المؤسسي المتعارف عليه عالميًا، حيث أثبتت التجارب المقارنة (مثل نيبال) أن ترتيب الخطوات -انتخابات، هيئة تأسيسية، دستور- هو شرط أساسي لتفادي الأزمات والانقسامات الدستورية , ولنا في التجربة المصرية الحديثة صورة يمكن التعلم منها فقد تم اجراء بعض التعديلات الدستورية من خلال الاستفتاء الشعبي بعد اسقاط نظام الرئيس مبارك وبعد اقرار هذه التعديلات ذهبت الدولة الى انتخاب مجلس الشعب والشورى ومن ثم تم تشكيل لجنة لصياغة ووضع دستور جديد وبعد اكتمال العملية التشريعية بخطوات تراتبية ومتدرجة جرت انتخابات رئاسية
الإشكالية في اشتراط الالتزام باتفاقية أوسلو وتهميش الفصائل
تشير بعض التصريحات الرسمية إلى اشتراط التزام القوى السياسية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني باتفاقية أوسلو. كما تُظهر تركيبة اللجنة تغييبًا لأحزاب وفصائل فلسطينية ذات حضور شعبي وسياسي وازن.
من منظور قانوني وسياسي، يثير ذلك إشكالات جوهرية عدة:
1. يتعارض مع مبدأ الشمولية الوطنية الذي أقرّته وثائق الحوار الوطني وقرارات المجالس الوطنية السابقة.
2. إقصاء قوى سياسية رئيسية يقوّض شرعية أي نص دستوري لاحق، ويحوّله إلى وثيقة طرف واحد لا إلى عقد اجتماعي جامع.
3. يتنافى مع الفقه الدستوري المقارن الذي يشدد على أن العملية التأسيسية يجب أن تكون شاملة وتوافقية لضمان الاستقرار والقبول المجتمعي. فقد نجحت تجارب جنوب أفريقيا (1996) وتونس (2014) بفضل الشمول والتوافق، بينما فشلت تجارب إقصائية كما في ليبيا بعد 2011.
4. يشكّل تجاوزًا للوظيفة التمثيلية للمجلس الوطني، الذي نصّت المادة (13) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أنه "يمثل كافة الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
إضافة إلى ذلك، فإن اشتراط الالتزام باتفاقيات سياسية محددة يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية الذي يجعل الدستور العقد الاجتماعي الأعلى، لا مجرد امتداد لاتفاقيات مرحلية. فالتجارب المقارنة لم تشترط على القوى السياسية الالتزام المسبق باتفاقيات معينة، بل اعتبرت العملية الدستورية نفسها فرصة لإعادة النظر أو تثبيت تلك الاتفاقيات.
كما أن فرض شروط أو قيود على الأطراف المسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية أو في صياغة الدستور يطرح تساؤلات حول مصدر الحق في فرض مثل هذه الشروط، ويؤدي إلى ارتباك في فهم تراتبية السلطة ومصادرها. والأجدر هو الالتزام بالمعايير الدولية في صياغة الوثائق الدستورية، بما يضمن الشمول والتنوع السياسي.
فالبيئة السياسية الفلسطينية، التي تضم أكثر من خمسة عشر حزبًا وفصيلًا سياسيًا، هي نتاج معركة طويلة في سبيل التحرر وبناء الدولة. ومن ثمّ، يجب فتح الأبواب أمام هذه القوى جميعًا للمشاركة المتساوية في صياغة الدستور، ليس فقط لتعزيز الشرعية، بل لتقديم صورة صادقة عن الشعب الفلسطيني ومدى وعيه بأهمية العمل السياسي والحزبي ودوره في صنع القرار.
الشرعية الإجرائية والقبول المجتمعي
تؤكد التجارب الدولية أن الشرعية الإجرائية لا تقل أهمية عن مضمون النصوص الدستورية. فإذا جرى تجاوز المؤسسات المنتخبة أو إقصاء أطراف أساسية، فإن أي دستور ناتج عن ذلك سيفتقد القبول المجتمعي. وقد أظهرت تجارب مثل العراق (2005) أن الإقصاء خلال العملية التأسيسية أدى إلى دستور ضعيف الشرعية وفاقد للإجماع الوطني، بينما ضمنت التوافقية والشمول في جنوب أفريقيا استقرار النظام الدستوري لسنوات لاحقة.
الخلاصة والتوصيات
من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة وربطها بالمبادئ الدستورية العالمية، يمكن استخلاص ما يلي:
• من غير الجائز قانونيًا الشروع في صياغة دستور قبل انتخاب مجلس وطني جديد، لأن المجلس الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح التفويض وصياغة الميثاق الدستوري، وهو ما تؤكده مبادئ الشرعية التمثيلية عالميًا.
• اشتراط الالتزام باتفاقيات سياسية محددة (مثل أوسلو) كمدخل للمشاركة يقوّض مبدأ التعددية السياسية، ويتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية الذي يجعل الدستور تعبيرًا عن الإرادة الجمعية لا عن اتفاق سياسي مرحلي.
• تهميش فصائل فلسطينية أساسية يفرغ العملية الدستورية من مضمونها الوطني، ويجعلها خطوة أحادية لا ترقى إلى مستوى الإصلاح أو المصالحة الوطنية، في تعارض واضح مع مبدأ الشمولية والتوافقية الذي يُعدّ قاعدة راسخة في الفقه الدستوري المقارن.
• الشرعية الإجرائية شرط أساسي لقبول أي نص دستوري. تجاوزها يجعل الدستور هشًّا وغير جامع، حتى وإن كان نصا متقدما.
المسار الصحيح يقتضي أولًا إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لتجديد الشرعية التمثيلية، وثانيًا تمكين هذا المجلس من تشكيل لجنة دستور جامعة تُشرك جميع القوى والفصائل الفلسطينية بلا إقصاء أو شروط مسبقة. بذلك فقط يمكن للدستور الفلسطيني أن يتحول إلى عقد اجتماعي جامع، يرسخ الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية، ويستند إلى الشرعية الإجرائية والشمولية، التي تعد من ركائز التجارب الدستورية الناجحة عالميًا.

تصريحات هركابي تكشف زيف سلام ترامب وتعزز الصراع الديني

احـتـلال مـرخّـص قـانـونـاً

من لا يزرع الأمل يزرع الرحيل...

ما بين "هنا القدس" و"هنا غزة" ... صوت وطن وصمود شعب

التويجري عن "جنايات أبو ظبي في حق الأمة": شموس الحق لا يحجبها غربال

بينما يحصي البعض صيحات الاستهجان، يحصي الفلسطينيون شهدائهم .. مفارقات النظام الدولي وأخلاق...

عندما تُختزل القضية الفلسطينية في إدارة غزة