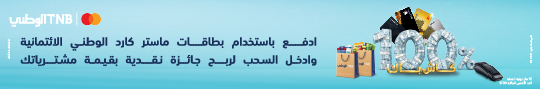عن "نهاية الاستعمار الاستيطاني في ظلّ الإبادة" لفيراتشيني...
"لا أرى أن ما يجري في غزّة هو ذروة الاستعمار الاستيطاني، بل أراه انحرافًا جذريًا عنه"، يقول لورينتسو فيراتشيني - أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في ملبورن الأسترالية - في مقالته "الإبادة الجماعية في غزّة ونهاية الاستعمار الاستيطاني"، التي ترجمها إلى العربية الباحث أنس إبراهيم ونشرها مؤخرًا مركز مدى الكرمل.
لطالما قُرئت إسرائيل بوصفها مجتمعًا استيطانيًا، والصهيونية منذ نشأتها كاستعمارٍ استيطاني. إلا أن مقالة فيراتشيني تحاجج بأن هذه القراءة التاريخية لإسرائيل والصهيونية لم تعد، بعد عامَي الحرب على غزّة، تفي بالغرض كإطارٍ تفسيري للإبادة الجارية في القطاع.
سبق أن ناقش الدكتور عزمي بشارة، في مقالة متصلة عن طبيعة إسرائيل قبل حرب الإبادة على غزّة في آب/أغسطس 2021 بعنوان: "استعمار استيطاني أم نظام أبارتهايد، هل علينا أن نختار؟"، هذا الإطار النظري، مشيرًا إلى فيراتشيني نفسه كواحد من الباحثين الذين عملوا على توظيف "الاستعمار الاستيطاني" لفهم المشروع الصهيوني قبل الحرب. وقد شرح فيراتشيني، بحسب بشارة، الفرق بين الاستعمار الكلاسيكي والاستعمار الاستيطاني من خلال الاختلاف بين عبارتين موجهتين إلى السكان الأصلانيين: "اعمل من أجلي" (الاستعمار الكلاسيكي)، و"اذهب من هنا" (الاستعمار الاستيطاني). تنبع الأولى من "منطق الاستغلال"، بينما تنبثق الثانية من "منطق الإلغاء" الذي يسعى إلى طرد السكان الأصليين والحلول محلهم.
وقد اتفق بشارة مع فيراتشيني في هذا التمييز، منبهًا إلى أن الفلسطينيين وعوا بدورهم هذا التمايز قبل فترة طويلة من صياغته أكاديميًا، إذ وصف الفلسطينيون الاستعمار الصهيوني منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بأنه استعمار استيطاني "إحلالي" أو "استبدالي". وإلا فما الذي قصده الفلسطينيون بالإحلالي؟ يسأل بشارة، الذي خلص في مقالته إلى أن المشروع الصهيوني زاوج بين نموذجين استعماريين منقرضين: الفرنسي في الجزائر، والهولندي في جنوب أفريقيا؛ فإسرائيل هي استعمار استيطاني منذ عام 1948، وقد أنشأت نظام أبارتهايد (فصل عنصري) بعد احتلالها الضفة والقطاع عام 1967.
لكن هذا كان قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحرب الإبادة المستمرة. ففي مقالته الأخيرة عن الحرب، يستعرض فيراتشيني آراء بعض الكتّاب والمثقفين الذين ظلوا يستدعون "الاستعمار الاستيطاني" كإطار نظري لتفسير إسرائيل في حربها على غزّة، بوصف الإبادة ذروة لهذا الاستعمار، ومن بينهم يهود مثل آفي شلايم. إلا أن فيراتشيني لم يعد يرى الإبادة ذروة الاستعمار الاستيطاني، بل انحرافًا عنه، لأن "الإبادة الجماعية هي ما يحدث عندما يفشل الاستعمار الاستيطاني"، ما يعني تجاوزه عدسة "الاستعمار الاستيطاني" لتفسير ما يحدث.
يظل "الاستعمار الاستيطاني" مقولة عالمية لتفسير واقع المجتمعات الاستيطانية المستقرة، ببرلمانات تشرّع قوانين للمستوطنين، ومستوطنين يتمتعون بحقوق استيطان ومستوى معيشة مرفّه. حيث يُقمع السكان الأصلانيون في هذه المجتمعات داخل حدود معترف بها دوليًا، عبر أدوات بنيوية للاحتواء والسيطرة. إذ لم يعد الموت الجماعي يليق بهذه الكيانات، التي باتت تفضّل القلق بشأن "تنعيم وسادة الاحتضار" الخاصة بـ "العرق الأصلي"، فأزمنة القتل وراءها كما يقول فيراتشيني.
يقصد بذلك مجتمعات الأميركيتين ونيوزيلندا وأستراليا. لكن إسرائيل، في نموذجها، تظل حالة مختلفة. يؤصّل فيراتشيني لمقولة "الاستعمار الاستيطاني" كإطار معرفي متصل بإسرائيل في مرحلتين: الأولى مع كتابات الباحث الفلسطيني فايز الصايغ في ستينيات القرن الماضي، إثر احتلال الضفة الغربية والقطاع. والثانية مع أعمال المفكر الماركسي ماكسيم رودنسون الذي درس الصهيونية بوصفها استعمارًا استيطانيًا، لتعود المقولة إلى التداول في أواخر التسعينيات وبداية الألفية مع تطورات أوسلو وانهيارها.
المسافة بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي مثّلت مرحلة سعت خلالها السياسات الإسرائيلية إلى إخضاع الفلسطينيين هرميًا أكثر من محوهم. ثم جاءت أوسلو، التي رأى فيها فيراتشيني لحظة استعمارية استيطانية مثلت "حلًا" أو تفكيكًا مجازيًا للاستعمار، إذ طبّعت الاستعمار الاستيطاني وحكم المستوطنين عبر خطاب الاعتراف والمصالحة وبناء علاقات أكثر احترامًا بين المستوطنين والمكونات الأصلانية أي الفلسطينيين.
غير أن ذلك سرعان ما انهار. فابتعد المجتمع الإسرائيلي عن نموذج الاستعمار الاستيطاني المستقر، مع إصرار إسرائيل على رفض أي أفق سياسي للفلسطينيين. وهو ما مثّل فشلًا استراتيجيًا للمشروع الصهيوني كاستعمار استيطاني. وعليه يتساءل فيراتشيني: هل ما نراه اليوم – أي حرب الإبادة على غزّة – هو "موت" الاستعمار الاستيطاني؟
كان فشل سياسة الدمج بعد احتلال 1967، ثم فشل أوسلو، بمثابة فشل للنموذج الاستيطاني. وإن كان ما اعتبره فيراتشيني "شبه نجاح" في مرحلة ما بين أواخر الستينيات والتسعينيات غير دقيق برأينا، فإن حرب الإبادة الجارية في غزّة استكمال لفشل هذا النموذج. إذ تغادر إسرائيل وبلا رجعة برأي فيراتشيني إطار الاستعمار الاستيطاني. فالنظام الذي يعود إلى أصوله الدموية ويتخلى عن أدوات القمع البنيوية إنما يدمّر نفسه. وفي الوقت الذي لم تعد فيه إسرائيل تنسجم مع النموذج كما "انسجمت" سابقًا، فإن الهجوم على غزّة والضفة معًا، وما يتطلبه من تعبئة دائمة، يرافقه تهميش لمكوّنات يهودية واسعة داخل إسرائيل، كما يقول فيراتشيني.
وأكثر من ذلك، يشير الكاتب إلى فكرة "الاستعمار الانفجاري" الذي عرّفته المجتمعات الاستيطانية الأخرى بتدفق دائم للمهاجرين المستوطنين إلى أراضي السكان الأصلانيين. لكن الهجوم على غزّة يقوّض هذا المسار، فإسرائيل فشلت خلال العقود الأخيرة في جذب موجات مهاجرين يهود جدد، بل إن كثيرين منهم يختارون اليوم المغادرة في ظل الإبادة، التي حوّلت إسرائيل إلى بلد هجرة خارجية. ذلك لأن الإرهاب الذي تمارسه في غزّة يهدّد بتفريغها من يهودها أكثر مما يهدّدهم "إرهاب" المقاومة الفلسطينية، كما يصفها فيراتشيني.
كان هذا مجمل ما جاءت به مقالة "الإبادة الجماعية في غزّة ونهاية الاستعمار الاستيطاني"، حيث حذّر صاحبها من أن الإبادة لا تعني فقط مغادرة إسرائيل لنموذج الاستعمار الاستيطاني، بل تهدد إسرائيل نفسها كمجتمع ومشروع. ومع كثير من ملاحظاتنا على ما طرحه فيراتشيني، خصوصًا في مقاربته لتاريخ المشروع الصهيوني إلى جانب تجارب استعمارية أخرى، يبقى جوهر المسألة أن سياسات المحو والإحلال الصهيونية لم تتوقف يومًا، وإن تبدلت نبرتها الخطابية. كما لم يعطِ الكاتب للدور الفلسطيني حقه في منع تحوّلهم إلى "هنود حمر" كما في تجارب استيطانية أخرى.
ومع ذلك، فإن الإبادة اليوم تعني محو الفلسطيني في غزّة وتدميرها، ذلك أن المشروع الصهيوني يحمل خصائص استعمارية تداوم على خلق مجتمعٍ صهيوني مستعد للتصالح مع أكثر نماذجه توحشًا.

تصريحات هركابي تكشف زيف سلام ترامب وتعزز الصراع الديني

احـتـلال مـرخّـص قـانـونـاً

من لا يزرع الأمل يزرع الرحيل...

ما بين "هنا القدس" و"هنا غزة" ... صوت وطن وصمود شعب

التويجري عن "جنايات أبو ظبي في حق الأمة": شموس الحق لا يحجبها غربال

بينما يحصي البعض صيحات الاستهجان، يحصي الفلسطينيون شهدائهم .. مفارقات النظام الدولي وأخلاق...

عندما تُختزل القضية الفلسطينية في إدارة غزة