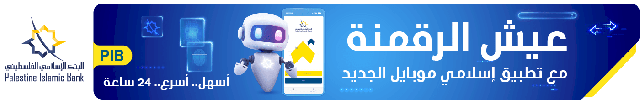أصدقاء واشنطن لا يصغون إليها
يبدو أن الزمن الذي كانت فيه «رغبات واشنطن أوامر»، ينضبط لها أصدقاؤها وحلفاؤها، ويتحسب لها كثيراً، خصومها وأعداؤها، قد ولّى، أو هو في طريقه إلى ذلك. صفحة الهيمنة الأميركية على النظام العالمي انقضت، ونظام «القطب الواحد» في هزيعه الأخير، والعالم يخوض غمار «تعددية قطبية» تتسم بقدر كبير من الفوضى واللايقين، إلى أن تتضح ملامح النظام العالمي الجديد.
تبدأ الحكاية من الضفة الأوروبية للأطلسي، حيث شهدت العلاقة بين شاطئيه، أكبر اهتزازة لها منذ الحرب العالمية الثانية، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم ينجح في إخفاء رغبته في تفكيك الاتحاد، وتشجيع بريطانيا على المضي قدماً في مشروع «بريكست»، ونال قادة «القارة العجوز» من لسانه الطويل الذي لا يهدأ عن «التغريد»، ما نالهم من أقذع الصفات، وأفضى ذلك كله إلى تآكل «مداميك» الثقة المتبادلة، قبل أن يأتي جو بايدن بخطاب جديد ومقاربة مختلفة.
لكن العام الأول على ولاية جو بايدن لن ينقضي قبل أن تتراجع الإدارة عن بعض من قواعد «مبدأ بايدن» في السياسة الخارجية: احترام التعددية وتعميق الشراكة عبر الأطلسي... أفغانستان والانسحاب الأميركي المتسرع والمنفرد، كان الشرارة الأولى التي دفعت بالأوروبيين لإبداء الحذر من مقاربة سيد البيض الجديد، حتى أن وزير خارجية فرنسا لم يتورع عن اتهامه بالسير على خطى سلفه، متهماً إياه بالضرب بعرض الحائط مصالح شركائه ومواقفهم. وفي صفقة الغواصات النووية مع أستراليا بدا أن بايدن يعطي الأولوية لبريطانيا في علاقاته العابرة للأطلسي على حساب الاتحاد الأوروبي، وجاء تحالف «أوكوس»، ليكرس نهجاً ترامبياً من دون ترامب، وليلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين شركاء الحرب الباردة.
كثيرة هي الملفات العالقة بين أوروبا والولايات المتحدة، من «غازبروم» والعلاقة مع الصين، وصولاً إلى المنافسة المحتدمة على أسواق السلاح، فضلاً عن بعض أزمات العالم المفتوحة. ما حدا بدول الاتحاد، وبالذات فرنسا وألمانيا، لإحياء مشاريع قديمة -جديدة عن «الجيش الأوروبي» والسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية. التطمينات المتبادلة بأن خطوات كهذه لن تكون بديلاً عن «الناتو» أو على حسابه لا تكفي لحجب الخلافات الكامنة تحت السطح.
في الإقليم، ليس صدفة أن أقرب حلفاء واشنطن إلى قلبها وعقلها ومصالحها، (إسرائيل) تقيم أوثق العلاقات مع ألد خصوم واشنطن ومنافسيها (الصين)، حتى أن الخلاف بشأن العلاقة الإسرائيلية – الصينية، بات اليوم، أحد ثلاث قضايا خلاف جوهرية بين إدارة بايدن وحكومة بينيت، إلى جانب إيران والمسألة الفلسطينية. الصين تدخل بقوة إلى قطاعات اقتصادية حساسة، وإسرائيل تعمل على تطوير «لوبي صهيوني» في الصين، ظناً منها أن المستقبل يعمل لصالحها، تماماً مثلما فعلت قبل مئة عام، حين شرعت في نقل مركز ثقل «اللوبي» من أوروبا إلى الولايات المتحدة الصاعدة كقوة رائدة في العالم.
تركيا كانت سبّاقة لكسر سياسة «الإملاءات الأميركية»، صفقة صواريخ «إس 400» أكبر دليل على فشل إدارتين تعاقبتا على البيت الأبيض، في إرغام أردوغان على التراجع عنها. أنقرة لم تليّن موقفها من كرد سورية رغم الضغوط الأميركية الهائلة، وقضايا الخلاف بين واشنطن وحكم العدالة والتنمية لا حصر لها.
إثيوبيا التي كان لواشنطن دور «ملهم» في منح رئيس وزرائها جائزة نوبل للسلام، تعجز الأخيرة اليوم عن دفع آبيي أحمد للجنوح لخيار السلم والتفاوض والتسويات مع مصر والسودان حول سد النهضة، ويقف الموفد الأميركي المخضرم جيفري فيلتمان عاجزاً عن منع انزلاق هذا البلد الكبير نحو حرب أهلية قد لا تنتهي بتقسيمها، فيما الصين تعزز قواعد نفوذها في هذه البقعة الإستراتيجية المطلة على القرن الأفريقي.
إيران، الدولة «العدوة» لواشنطن منذ أزيد من أربعة عقود تجد نفسها اليوم أكثر ثقة بالنفس في صراعها متعدد المجالات مع واشنطن، لديها قواعد إسناد في موسكو وبكين، ولديها أفق مفتوح مع الهند والباكستان ومعاهدة شنغهاي، وعلاقاتها الناشئة مع الضفة الأخرى من الخليج العربي تسهم في تفكيك أطواق عزلتها، وهي تذهب إلى فيينا وبين يديها أوراق عديدة كذلك.
الدول العربية التي استمرأت تاريخياً، علاقة «الاستتباع» للولايات المتحدة، مسّها شيء من الرغبة في التمرد. ولي العهد السعودي يشق طريقاً التفافياً نحو طهران عبر القناة البغدادية، وهو تحدث عن الولايات المتحدة بوصفها واحدة من القوى العظمى، وليست القوة المهيمنة، وتوعد بتنويع علاقات وتحالفات وأسواق بلاده مع المراكز العالمية الناشئة، وهو يقبض على سقوف الإنتاج والأسعار في سوق النفط والطاقة، غير آبه بمواقف سيد البيت الأبيض وتهديده ووعيده. هوامش المناورة أمام المملكة تتسع، وهي لا تشعر بأن مبتدأ جملتها السياسية وخبرها يجب أن ينحصرا بالتسبيح بحمد الولايات المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة، القوة الثانية في الخليج، ورائدة مسار «أبراهام» واتفاقاته التطبيعية، وأول دولة عربية ستحصل على طائرات إف 35 الأميركية المتطورة، تشق «طريق حرير» خاصاً بها، يمر بإيران، الدولة المزعزعة للاستقرار كما في الخطاب الأميركي، ولا ينتهي في تركيا، الدولة التي تتسبب للبيت الأبيض بكثير من الصداع. علاقات تجارية مزدهرة ومتشعبة، وعلاقات تعاون أمني وسياسي من تحت الطاولة، لا تخفى مراميها على أحد، وهي لا تمانع «مناكفة» واشنطن في أثيوبيا بدعمها لآبيي أحمد، أو في ليبيا وسورية وغيرها من ملفات المنطقة.
موفدو واشنطن إلى القرن الأفريقي وإيران وفلسطين والعراق وبقية دول المنطقة، يجوبون المنطقة جيئة وذهاباً، من دون أن ينجحوا في تسجيل أي اختراق يذكر على أي من جبهات التوتر المذكورة. حتى بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، عجزت واشنطن من خلف باريس، عن زحزحة أحزاب طوائف وحارات وميليشيات عن مواقفهم المتعنتة التي أدت بهذا البلد إلى الانهيار. وفي السودان، لم يكن الوضع أفضل مع ثنائي العسكر: البرهان وحميدتي.
لم تعد لواشنطن «الهيبة» التي كانت لها زمن «القطبين»، وبالذات في زمن «القطب الواحد»، ومع تآكل «الهيبة» تتآكل «الهيمنة» على الساحة الدولية وساحات الإقليم، وحلفاء واشنطن وأصدقاؤها ما عادوا يصغون لها كما كانوا يفعلون من قبل، ودول الإقليم تبحث عن خيارات وبدائل وتحالفات جديدة، فيما بينها ومع بعض الأقطاب الدولية الناشئة استعداداً لملء الفراغ الأميركي، وتعويضاً عن انصراف الجهد والموارد الأميركية صوب المحيطين»: الهادئ والهندي.
لكن ذلك، لن يمنع أبداً من الاعتراف بأن الولايات المتحدة ستظل، حتى إشعار آخر، لاعباً دولياً وإقليمياً مهماً، بل اللاعب الأول على المسرحين العالمي والإقليمي. ما تغير هو أن واشنطن، لم تعد لاعباً أوحداً أو لاعباً مهيمناً، وقيادتها للعالم والإقليم بدأت تواجه تحديات يختلف المراقبون والمحللون في تقدير قدرة واشنطن على مواجهتها، والتعامل معها.

دعوةٌ للتخايل: ماذا لو كانت الشراكةُ(العرب وايران ) طريقًا لا صراع؟

الشرعية القانونية لاستهداف أيزان للقواعد العسكرية ألأمريكييه في الخليج - مقاربة في القانو...

هل نحن أمام نسخة جديدة من طوكيو وبرلين؟ قراءة في فكرة "مجلس السلام"

تحذيرات عاجلة في زمن التصعيد: السلامة أولاً فوق كل إعتبار

إيران تُشعل المنطقة والخليج يحسب خطواته بحذر

لم يطلب أحد أن تسلم حماس سلاحها لإسرائيل

كيف يمكن تحويل الاتفاقيات الاقتصادية من استجابة ظرفية إلى مشروع بنيوي مستدام في فلسطين؟