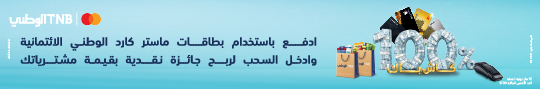فلسفة السيادة والعدالة في مشروع ترامب لغزة
تشكل خطة ترامب التي أُعلن عنها في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2025 بشأن قطاع غزة محطة جديدة في سلسلة المبادرات السياسية التي تتقاطع عندها رهانات القوة، والحسابات الجيوسياسية، والتطلعات الاستراتيجية للقوى الكبرى. فهي ليست مجرد مبادرة تقنية أو تسوية وقتية تهدف إلى وقف دورة العنف المستمرة، بل تحمل في طياتها مشروعًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في غزة، وإعادة رسم حدود السيادة وحدود القرار الفلسطيني.
هذه الخطة تأتي في سياق تاريخي طويل من المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لصياغة "حلول" تضع الفلسطينيين أمام خيارات محدودة، وتحوّل الصراع من سؤال الحرية والعدالة إلى معادلات أمنية واقتصادية محكومة بميزان القوى.
ومن هنا، فإن التعامل مع الخطة لا ينبغي أن يقتصر على تفكيك أبعادها السياسية والعملية، بل يتطلب مقاربة فلسفية تطرح أسئلة أعمق حول المعنى والسلطة والعدالة والمصير. فجوهر القضية لا يتعلق فقط بترتيبات أمنية أو مشاريع إعمار، بل يتصل بجدلية أساسية: من يملك الحق في أن يقرر مصير جماعة بشرية؟ وهل يُختزل السلام في غياب الحرب، أم يقوم على حضور العدالة بوصفها قيمة إنسانية مطلقة؟
منطق الخطة يقوم على أن السيادة الفلسطينية مؤجلة ومرهونة بشروط الإصلاح والإشراف الدولي، ما يعني أن سكان غزة ليسوا فاعلين في صياغة مستقبلهم، بل موضوعًا لقرارات خارجية. فالمبادرة، كما صيغت، تحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وتجعل أي تغيير أو تحول مشروطًا برقابة دولية.
كما أن الخطة تنزع الوكالة عن أهل غزة وتضعهم تحت وصاية مجلس سلام برئاسة ترامب بوصفه المرجع الأعلى، وهو ما يعيد إلى الواجهة فكرة الحاكم المستعمر في الفلسفة السياسية، إذ أن تصور هوبز حول ضرورة وجود سلطة مطلقة لضمان الأمن والنظام يمكن أن يُستخدم لتبرير الحكم الاستعماري، حيث يصبح وجود قوة تفرض سيطرتها أمرًا حتميًا لاستمرار الاستقرار.
وتكشف القراءة أيضًا عن جدل فلسفي بين العدل والمنفعة؛ إذ يقوم العرض على مقايضات إنسانية وسياسية: رهائن مقابل أسرى، السلاح مقابل العفو، الأرض مقابل إعادة الإعمار. هذا المنطق يقترب من مقاربة النفعية التي تسعى إلى تحقيق أكبر منفعة وأقل ضرر. لكن السؤال الجوهري هو: هل تُقاس العدالة بالمقايضات، أم أنها مبدأ مطلق غير قابل للمساومة؟ وفق الرؤية الكانطية، الإنسان غاية في ذاته لا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يتناقض مع منطق المبادلة الذي تبنته الخطة. فالفلسفة الكانطية تؤكد على العدالة كقيمة مطلقة غير قابلة للتجزئة أو التفاوض.
وتتضمن الخطة شرطًا جوهريًا يتمثل في نزع سلاح حماس مقابل وعود بالتعايش السلمي. إلا أن هذا يثير تساؤلًا فلسفيًا: إذا جرى نزع أدوات العنف دون إعادة سلطة شرعية حقيقية للفلسطينيين، فهل سيكون هناك سلام أم مجرد هدوء مفروض بالقوة؟ هذه المفارقة تعيد النقاش إلى سؤال فلسفة السلام: هل يُعرّف السلام بغياب الحرب فقط، أم بحضور العدالة أيضًا؟ هذه المقاربة تعكس عقلية تعتبر السيطرة الأمنية أكثر أهمية من العدالة، وترى في وقف القتل غاية بحد ذاتها بصرف النظر عن حقوق الفلسطينيين.
وتبشر الخطة بما تسميه غزة مزدهرة، قائمة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة وتوفير فرص عمل واستثمارات. هذا الخطاب التكنوقراطي يعامل غزة بوصفها مشروعًا تنمويًا يعتمد على البنية التحتية والأرقام الاقتصادية، فيما تُهمش القيم الجوهرية مثل التاريخ والهوية والحرية والعدالة.
من منظور فلسفي، يعكس هذا ما يُعرف بالعقل الأداتي الذي يركز على الفعالية والجدوى الاقتصادية متجاهلًا الأبعاد الأخلاقية والإنسانية. هذا الطرح يمثل رغبة في تحويل غزة إلى مشروع عمراني تحت إشراف خارجي، مع إقصاء الفلسطينيين عن المشاركة في صياغة مستقبلهم.
وفي الختام، يتضح أن تجاهل الحقوق الفلسطينية والأدوار العربية يكشف عن عقلية تركز على السيطرة المطلقة وتغليب النتائج العملية على حساب العدالة والكرامة. فالخطة تجسد رؤية للسلام باعتباره إدارة للأزمة لا عدالة للشعوب، إذ تحوّل المأساة إلى مشروع عمراني اقتصادي يخضع لوصاية دولية، لكنها في الوقت ذاته تتجاهل الأسئلة الأساسية: من يقرر؟ من يحاسب؟ وما معنى الحرية بعد نزع السلاح وإعادة الإعمار؟ في جوهرها، هي رؤية لسلام بلا ذاكرة، وتنمية بلا سيادة، قد تزرع بذور نزاع جديد يعيد إنتاج العنف بدل أن يضع حدًا له.

تصريحات هركابي تكشف زيف سلام ترامب وتعزز الصراع الديني

احـتـلال مـرخّـص قـانـونـاً

من لا يزرع الأمل يزرع الرحيل...

ما بين "هنا القدس" و"هنا غزة" ... صوت وطن وصمود شعب

التويجري عن "جنايات أبو ظبي في حق الأمة": شموس الحق لا يحجبها غربال

بينما يحصي البعض صيحات الاستهجان، يحصي الفلسطينيون شهدائهم .. مفارقات النظام الدولي وأخلاق...

عندما تُختزل القضية الفلسطينية في إدارة غزة