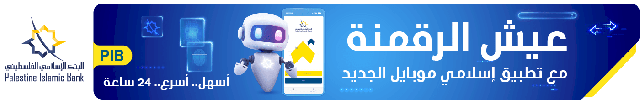تونس: هل من "عقلاء" لوضع حد لهذا التدهور؟
الكل يطالب «العقلاء» بالتدخل والكل يطالب «الحكماء» بالتحرك.
في تونس اليوم، لم يعد ينقص سوى الإعلان عن «وظيفة عاقل أو حكيم» بدوام كامل علّه يستطيع أن يفك الأزمة السياسية الحالية في البلاد المتمثلة في عض أصابع متواصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة التي تقف وراءها أغلبية برلمانية. المؤلم أكثر أن هذا العض يجري في مناخ اقتصادي واجتماعي وصحي متهالك كان يفترض أن تتحرك فيه كل الأيادي والأصابع لمعالجته عوض الانشغال بعضٍّ يشبه عضَّ أطفال مشاغبين تركتهم أمهم بمفردهم في البيت دون رعاية.
نحن الآن أمام مشهد غير مسبوق يقف فيه رئيس الدولة قيس سعيّد رافضا قبول الوزراء الجدد الأحد عشر لأداء اليمين الدستورية مع ما في ذلك من تعطيل للسير السليم لدواليب الدولة، فيما يحاول رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي لا ذنب له أن وجد نفسه في منصب لا يحسد عليه، تدوير الزوايا الحادة ومحاولة إبقاء الأمل في إصلاح العلاقة بينه وبين الرئيس. أما رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يعدّ هو الآخر أحد عناوين الأزمة في البلاد، فلم يتردد في الإعراب عن أن الحل قد يكون الذهاب بالنظام السياسي في تونس من برلماني معدّل إلى برلماني كامل، مقابل من يرى أن العكس هو الأصوب أي العودة إلى النظام الرئاسي. ووراء كل واحد يقف الآن من يقف، معتقدا أن موقفه الأصح والأنسب.
وبالعودة إلى «الحكماء» و«العقلاء» فإن تونس لم تكن يوما عاقرا عن إنجاب أمثال هؤلاء وقد كان لهم في أكثر من ظرف، خلال حكم الرئيس بورقيبة أو حتى بن علي ماعدا سنواته الأخيرة، دور كبير في إخماد حرائق عديدة قبل أن تلتهم البيت كلّه. نذكر من بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر، المرحوم حسيب بن عمار الوزير الأسبق ومدير جريدة «الرأي» الأسبوعية التي توقفت عن الصدور قبل أكثر من ثلاثين عاما والدكتور حمودة بن سلامة الوزير الأسبق والمعارض لسنوات وكذلك الدكتور سعد الدين الزمرلي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» لسنوات.
هذا الانحدار في التعامل بين أغلب الفرقاء السياسيين، حتى تحت قبة البرلمان، وصل الآن إلى درجة البذاءة والألفاظ النابية في المظاهرة الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة
الآن للأسف، يبدو وكأن هذا المعدن من الرجال القادرين على التوفيق وتهدئة الخواطر واجتراح الحلول قد انقرض، أو ربما خيّر الانزواء في مشهد لم يعد يسمح لكثير من الرجال المحترمين بالتحرك بعد أن عجَّ بصخب الغوغاء والشعبويين والهواة والفاسدين والمتلونين وبائعي الأوهام والانتهازيين والدجّالين. يضاف إلى ذلك ما بات يلعبه بعض الإعلام من دور تخريبي واضح ومخطط له إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك» إلى درجة جعلت أحمد الكيلاني أحد الوجوه اليسارية المعارضة إلى وصف تونس بـ«جمهورية فيسبوك» بعد أن أصبحت الكثير من المعارك والحملات تخاض هناك تحديدا مع انحدار في المستوى لمعظم ما يكتب.
هذا الانحدار في التعامل بين أغلب الفرقاء السياسيين، حتى تحت قبة البرلمان، وصل الآن إلى درجة البذاءة والألفاظ النابية في المظاهرة الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة، دعما للمظاهرات الاحتجاجية في الأيام الماضية ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فيها، حين شهدت شعارات وتصرفات لا علاقة لها بحرية التعبير والتظاهر وتعكس مستوى شعبيا بات ينافس المستوى السياسي في التدهور الأخلاقي أو ربما هو رجع صدى له.
وسط هذه الأجواء المتوترة وتزايد أعداد المصابين والضحايا بوباء الكورونا، يجد القصر الرئاسي الظرف مناسبا ليخرج للرأي العام الوطني والدولي برواية «محاولة تسميم الرئيس» والظرف المريب الذي وصله. بدت هذه القصة متعثرة وغير مقنعة خاصة مع تعدد الروايات وغرابتها وتناقضاتها لاسيما بعد قالت النيابة العامة إنها لم تجد شيئا في الظرف الذي وصلها من الرئاسة. مع ذلك واصلت الرئاسة الخوض في الأمر وتلقي الاتصالات المتضامنة مع بيانات أحزاب أشبه بمحاولة رفع عتاب وتسجيل حضور، فالقصة إن تأكدت رسميا وبالتحقيق المهني تعتبر خطيرة للغاية، أما إذا كانت مفتعلة فهي مسرحية تستوجب معاقبة مؤلفها ومخرجها وكاتب السيناريو الرديء جدا.
من المؤلم حقا أن نقرأ ما كتب في جريدة «النهار» اللبنانية مؤخرا بقلم أسعد عبود أحد كتابها من أن «تونسيين كثراً من بين الذين فرحوا بسقوط بن علي، مفجوعون اليوم بتعاظم خيبة الأمل في نفوسهم من عدم قدرة الطبقة السياسية على تأسيس حكم مستقر وتوفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لشبان، إما عادوا إلى الاحتجاج في الشوارع أو يركبون قوارب الموت نحو أوروبا بحثاً عن حياة جديدة» لينهي بالقول «ربما أضاعت تونس لحظتها التاريخية أو كادت».
وحتى لا تضيع هذه اللحظة التاريخية بالكامل فيعضّ الجميع الأصابع، ندما هذه المرة لا مناكفة، فإن الأمل مع ذلك ما زال قائما، وإن كان ضئيلا ويتناقص، في أن يتقدم بعض العقلاء والحكماء لينهوا العبث الجاري حاليا قبل أن يسقط البيت على رأس الجميع لا سمح الله فنكون كمن ينطبق عليهم القول «من كان في نعمة ولم يشكر، خرج منها ولم يشعر».
وهل من نعمة أكبر وأهم من نعمة الحرية؟!

لم يطلب أحد أن تسلم حماس سلاحها لإسرائيل

كيف يمكن تحويل الاتفاقيات الاقتصادية من استجابة ظرفية إلى مشروع بنيوي مستدام في فلسطين؟

حين تصبح الأزمة وظيفة كيف كشفت الحرب نموذج إدارة الاقتصاد؟

لماذا تموت مريم دائمًا؟

الحرب على إيران: إعادة هندسة الإقليم لا إسقاطه

من غاندي ونهرو إلى ناريندرا مودي.. ما الذي تغيّر؟ الهند أم فلسطين أم العالم؟

المؤتمر الثامن وصراع التيارات الفتحاوية