
وتظل مفاتيح الحرب والسلام بيد فلسطين
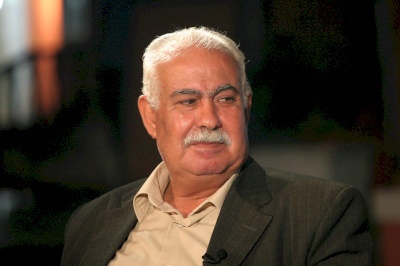
ليس غريباً، أن يعلن الرئيس الأميركي، بأن وجود قواته وإمكانياته في الشرق الأوسط هو لخدمة وحماية إسرائيل، فكلاهما امتداد لبعضهما كقوى استعمارية. أمر العلاقة بين أميركا وإسرائيل لا يتصل بالأخلاقيات، ولا بالدوافع، الشخصية أو الفئوية، ولا بمنظومات القيم الإنسانية، فبما أن أميركا تورثت زعامة المعسكر الاستعماري من بريطانيا، فإنها تتابع ذات الأهداف وتتبع الوسائل ذاتها. من المؤسف أن يلدغ العرب مرات ومرات، ولا يتعلمون من تجاربهم التاريخية.
كان الشريف حسين قد أبرم اتفاقاً وحصل على وعود من بريطانيا وفرنسا، قبل الحرب العالمية الأولى، لكنهما انقلبتا على تلك الوعود، بعد وقت قصير، وعقدتا اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وصدر وعد بلفور عام 1917.
الهدف دائماً كان ولا يزال للقوى الاستعمارية، تقسيم المقسّم العربي، والسيطرة على ثروات الجميع، ومنع قيام أي مشروع قومي عربي نهضوي. ربما ينسى أو يتناسى العرب وقائع التاريخ، لكن حاضر الوقائع يؤكد السياق ذاته.
تصريحات كثيرة على مدار عقود كثيرة، صدرت عن مراكز أبحاث إسرائيلية وعن قيادات الحركة الصهيونية، كانت شديدة الوضوح، فيما يتعلق بأهداف إسرائيل وأبعاد مشروعها الاستعماري، لكن أحداً لا يريد أن يصدق أن الوقائع اللاحقة والجارية تضفي مصداقية شديدة على تلك المخرجات.
النتائج على الأرض جاءت لتؤكد أن كل ما يجري مرسوم مسبقاً وباتفاق حتى أن الكثيرين، حين يعودون للتذكير بما سبق للإسرائيليين إعلانه في سنوات سابقة، يؤكدون، أن ما يقع كأنه ترجمة فعلية وتفصيلية لما أعلنته مصادر إسرائيلية.
وحتى لا يكون الكلام جزافاً وعاماً، فإن من يشكك في هذه الحقيقة عليه أن يراجع ما صدر عن معهد جافي عام 1989، وعليه أيضاً أن يراجع مذكرات شارون وشمعون بيريس، ونتنياهو. لا حاجة للعودة إلى النشيد الوطني الإسرائيلي، أو إلى ما يرمز إليه العلم ويكفي التذكير بما صرح به شمعون بيريس ذات يوم حين قال إن المزاوجة أو الشراكة بين المال العربي واليد العاملة، مع التكنولوجيا الإسرائيلية يحيل هذه المنطقة إلى جنة ، وهو أول من تحدث عن الشرق الأوسط الجديد.
يعتقد المطبعون أنه يمكن الفصل بين المصالح الوطنية والمصالح القومية، وأن أولويتهم تلزمهم، أو تقودهم إلى حماية مصائر أنظمتهم وبلدانهم حتى لو كان ذلك على حساب المصالح العربية المشتركة. وفق هذا المنظور، لا نشاهد تطبيعاً متدرجاً ورزيناً، هناك حالة انهيار شامل وركض في كل الاتجاهات، لتحقيق شراكة كاملة مع إسرائيل، إلى درجة قد تفوق عناصر التحالف.
لم يحصل هذا مع الفلسطينيين يوماً، فلقد كانت المساعدات محدودة ومحسوبة، وموظفة، ومغلفة بخطابات تدعي الالتزام بالحقوق العربية المهدورة. سبحان الله بين ليلة وضحاها انقلبت العقول، والتوَت الألسنة، وتغيرت وقائع التاريخ، والتحالفات، فيجري الغزل بإسرائيل والتاريخ اليهودي، وفي الوقت ذاته النهش بالرواية الفلسطينية والعربية وإلقاء التهم على أبناء جلدتهم.
إذا كان المثل الشعبي الشائع يقول: أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فإن المطبعين حوّلوا ذلك إلى: أنا وابن عمي على أخي، وأنا والغريب على أخي، أيضاً.
لا شكّ أن ثمة ذريعة يجري تضخيمها، بالحديث عن الخطر الايراني مرة وعن الخطر التركي مرة أخرى، لتبرير هذا الاندلاق على العلاقة حد التحالف مع أعداء الأمة العربية. هناك استراتيجيات ايرانية وأخرى تركية تزاحم على السيطرة والنفوذ في المنطقة، ولكن هل من الصحيح أن يلجأ العرب أو بعضهم إلى عدوهم، وعدو الشعوب، لمواجهة ذلك؟ لماذا لا يكون خيارهم الأول، الاعتماد على مشروع عربي مشترك، والاستناد الى الشعوب العربية لمواجهة كل اشكال المخاطر التي تهدد المصالح الوطنية والقومية؟
مشاهد الاحتفال الذي وقع في حديقة البيت الابيض، أول من أمس تكرر خلال العقود المنصرمة، بداية باتفاقية كامب ديفيد، أيام رئاسة جيمي كارتر، واتفاقية أوسلو، برعاية بيل كلينتون، واتفاقية وادي عربة، أيضاً، في زمن كلينتون، فماذا كانت المحصّلة؟ الرئيس ترامب يعد إسرائيل بمزيد من هذه الاحتفالات، ولا نظنّه يبالغ حين يتحدث عن خمس أو ست دول عربية أخرى في الطريق نحو حديقة البيت الأبيض.
لقد انهارت ثقة الفلسطينيين، وربما الشعوب العربية، بقيادات وأنظمة هذا الزمان، ما يستوجب الارتداد إلى الحصن الذاتي، باعتباره الخيار صفر بالنسبة للفلسطينيين ونحو إعادة بناء الذات وفق متطلبات مرحلة التحرر الوطني، بعيداً عن أوهام البحث عن طرق أخرى لانتزاع الحقوق الوطنية.
لقد اكتشف الفلسطينيون قبل غيرهم وأكثر من غيرهم طبيعة هذه الدولة العنصرية الاستعمارية التوسعية، ومدى استعدادها للالتزام بما توقع عليه حكوماتها من اتفاقيات سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم، خصوصاً حين تشكل هذه الاتفاقيات عقبة ولو صغيرة أمام إمكانية تحقيق الاستراتيجيات والأهداف الصهيونية.
إسرائيل لم تربح حرباً على المطبعين، ولكنها تشكل تهديداً لمصالح تلك الدول، ولذلك تبدو هذه الهرولة نحو العلاقة مع إسرائيل، والانصياع للضغوط الأميركية وتهديداتها أمراً غير مفهوم، إلاّ إذا كان هؤلاء في غيبوبة، أو انهم منذ وقت مبكر موجودون لتحقيق ذلك.
لسنا على اطلاع بما تم التوقيع عليه في حديقة البيت الأبيض، وثمة شك كبير في أن يجري الكشف عن كل ما تم التوقيع عليه، ولا يهم ابداً، إن كان ثمة ما يتعلق بتنازلات اسرائيلية، أو ضمانات تتعلق بالضم أو غيره مما يتصل بالفلسطينيين وحقوقهم. فليقولوا ما يشاؤون ولكن عليهم أن يتابعوا ما يصدر عن إسرائيل التي لا تعلن على نحو واضح ومحسوم تراجعها تماماً عن فكرة الضمّ، أو التزامها بدولة فلسطينية حتى بالحدود التافهة التي تضمنتها «صفقة القرن»، فضلاً عن معارضتها الواضحة لمبدأ بيع الأميركيين طائرات من نوع «ف 35».
سيمضي قطار التطبيع، والأرجح أن يلتحق به آخرون، طالما أن هذا الملف يحظى بتركيز شديد من قبل الإدارة الأميركية، وستبدأ مع الوقت إسرائيل في التنصل من بعض القيود، إن كانت هناك قيود على تنفيذ استراتيجياتها.
الاستيطان سيستمر، ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وفرض السياسات العدوانية التوسعية فيما تسميه إسرائيل «أرض الآباء والأجداد»، و»يهودا والسامرة». وفي الاتجاه الآخر، لا تخفي إسرائيل مساعيها لأن تحصل على ثمن كبير ونوعي، من الولايات المتحدة، وقد تكون حصلت على وعود بشأن تزويدها بأسلحة وذخائر وضمانات، للحفاظ على تفوقها العسكري والأمني في المنطقة بأسرها.
تحرص إسرائيل على أن تقبض الثمن من العرب المطبعين وغير المطبعين، ومن الولايات المتحدة وغيرها، مقابل هذا السلام المزيف، الذي لن يصمد طويلاً طالما أن مفاتيح الحرب والسلام في هذه المنطقة بيد فلسطين، والتي عليها أن تثبت جدارتها وقدرتها على تأكيد ذلك.